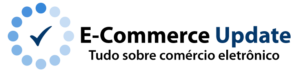قلّما كان للتقنيات في التاريخ الحديث تأثيرٌ سريعٌ وواسع النطاق مثل الذكاء الاصطناعي. ففي غضون سنواتٍ قليلة، تحوّل من تجربةٍ معمليةٍ إلى عنصرٍ محوريٍّ في العمليات التجارية، وسلاسل الإنتاج، وعمليات صنع القرار. ولكن بينما تُعامله بعض الشركات بالفعل كجزءٍ أساسيٍّ من استراتيجيتها، لا تزال شركاتٌ أخرى تُراقبه عن بُعد، وتُقيّم المخاطر والفوائد. يُخلق هذا الاختلاف في المواقف فجوةً تنافسيةً صامتةً، وإن كانت عميقة، تُشكّل خندقًا قد يُحدّد مستقبل النزاعات بين الشركات.
داخليًا، أفادت مايكروسوفت أن أكثر من 85% من شركات فورتشن 500 تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وأن ما يقرب من 70% منها تدمج Microsoft 365 Copilot في سير عملها، مما يُدمج هذه التقنية مباشرةً في العمليات الاستراتيجية. واستكمالًا لهذا المشهد، كشف بحث IDC العالمي، "فرصة الأعمال للذكاء الاصطناعي"، أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي قفز من 55% في عام 2023 إلى 75% في عام 2024، ويتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى 632 مليار دولار بحلول عام 2028. تُبرز هذه الأرقام أن التبني المبكر للذكاء الاصطناعي أصبح عاملًا حاسمًا في التنافسية، مما يُميز الشركات التي تقود التحول الرقمي عن تلك التي لا تزال تُراقب من بعيد.
لا يكمن التغيير الحقيقي الذي يُحدثه الذكاء الاصطناعي في أتمتة المهام أو خفض التكاليف فحسب، بل في تغيير منطق خلق القيمة نفسه. فبالتبني المبكر، لم تعد التكنولوجيا تُعتبر أداةً، بل أصبحت محركًا للتحول الهيكلي. في الشركات التي تُدمجها بالفعل في سير عملها، يُصبح كل منتج أو خدمة تُقدمها دورة تعلم، حيث تُغذي البيانات النماذج، وتُحسّن العمليات، وتُولّد عمليات تسليم جديدة وأكثر كفاءة وحزمًا. إنها آلية تسريع مُركبة، حيث يتوقف الوقت عن كونه مجرد مورد ويصبح مُضاعفًا للمزايا.
تُنشئ هذه الديناميكية نوعًا من الحواجز التنافسية التي لا تستند إلى براءات الاختراع أو البنية التحتية أو رأس المال، بل إلى المعرفة المتراكمة المُدونة في أنظمة ذكية. تُصبح النماذج المُدربة ببيانات خاصة، والعمليات الداخلية المُحسّنة، والفرق المُكيفة للعمل في تكافل مع الخوارزميات أصولًا يستحيل تكرارها بسرعة. حتى لو كان لدى المُنافس ميزانية أكبر، فلن يتمكن ببساطة من شراء وقت التعلم والنضج التشغيلي لأولئك الذين بدأوا أولاً.
ومع ذلك، لا تزال معظم المؤسسات عالقة في وضع انتظار حذر. تُصبح لجان التقييم، والمخاوف القانونية، وعدم اليقين الفني، والنزاعات الداخلية حول الأولويات حواجز مفروضة ذاتيًا أمام التبني. رغم مشروعية هذه المخاوف، إلا أنها غالبًا ما تُخفي حالة من الجمود، إذ تنتظر الشركات الأكثر مرونةً اللحظة المثالية، حيث تُراكم بالفعل الخبرة والبيانات وثقافة تشغيلية قائمة على الذكاء الاصطناعي. وبناءً على ذلك، فإن التردد لا يعني الركود؛ بل يعني التراجع.
ويبرز تأثير هذا التبني كمنطق جديد للتوسع، حيث يمكن للشركات الرشيقة ذات الفرق الصغيرة أن تُحدث تأثيرًا لا يتناسب مع حجمها. ومع دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات، يُمكن اختبار فرضيات متعددة في آنٍ واحد، وإطلاق إصدارات مُنتجة في دورات مُتسارعة، والتفاعل الفوري مع سلوك السوق. تُمثل هذه القدرة على التكيف المُستمر تحديًا للهياكل المؤسسية التقليدية، التي لا تزال تعتمد على دورات موافقة وتنفيذ طويلة.
وفي الوقت نفسه، يُشجع التبني المُبكر على إنشاء منظومة ابتكار داخلية. تبدأ الفرق بالعمل في تفاعل مُستمر مع الأنظمة الذكية، مُطورةً ثقافة التحسين المُستمر والتجريب. ولا تأتي القيمة من التكنولوجيا نفسها فحسب، بل من العقلية التي تُعززها، من خلال اتخاذ القرارات السريعة، والتحقق من صحة الأفكار على نطاق واسع، وتقليص الفجوة بين التصور والتنفيذ. الشركات التي تتبنى هذا النموذج تعمل بمرونة لا تضاهيها هياكل أبطأ، حتى مع امتلاكها موارد أكبر.
يطرح هذا السيناريو سؤالاً استراتيجياً لا مفر منه: الميزة التنافسية في القرن الحادي والعشرين ستتحقق لمن يُسرّع منحنى التعلم أولاً. لم تعد المعضلة "هل" أو "متى" نعتمد الذكاء الاصطناعي، بل "كيف" و"بأي سرعة". قد يعني التأخر في اتخاذ القرارات فقدان الأهمية في الأسواق التي يعتمد فيها التمايز بشكل متزايد على البيانات والخوارزميات وسرعة التكيف.
يزخر تاريخ الشركات بأمثلة لقادة خسروا مكانتهم بسبب الاستخفاف بالابتكارات الناشئة. مع الذكاء الاصطناعي، يتجلى هذا الخطر بشكل أوضح: فهو ليس تقنية يمكن تبنيها متأخراً دون خسارة تنافسية. يُحفر " الخندق " الخفي ويتعمق يوماً بعد يوم، بينما تظل الشركات عالقة في التحليل، بينما تُحوّل شركات أخرى، أكثر جرأة، هذا التوقع إلى هيمنة على السوق.